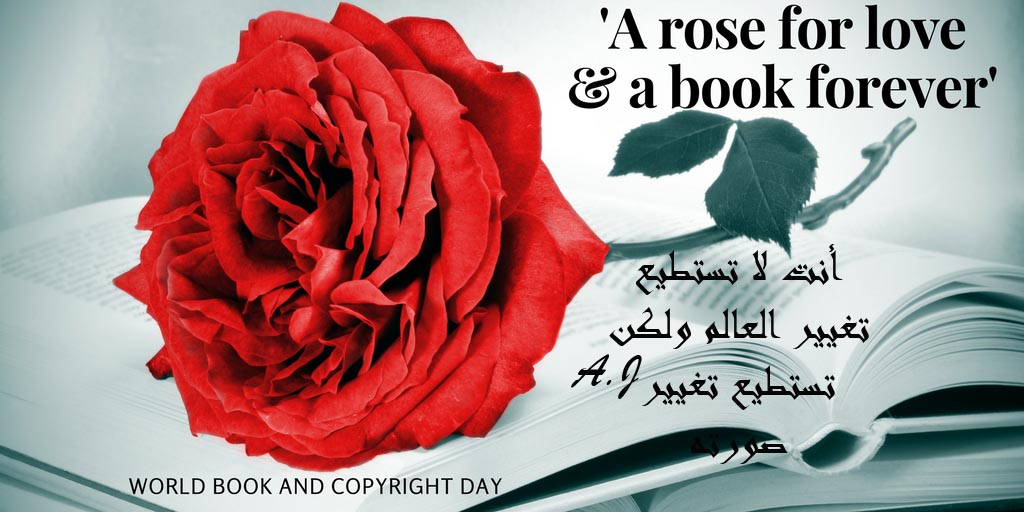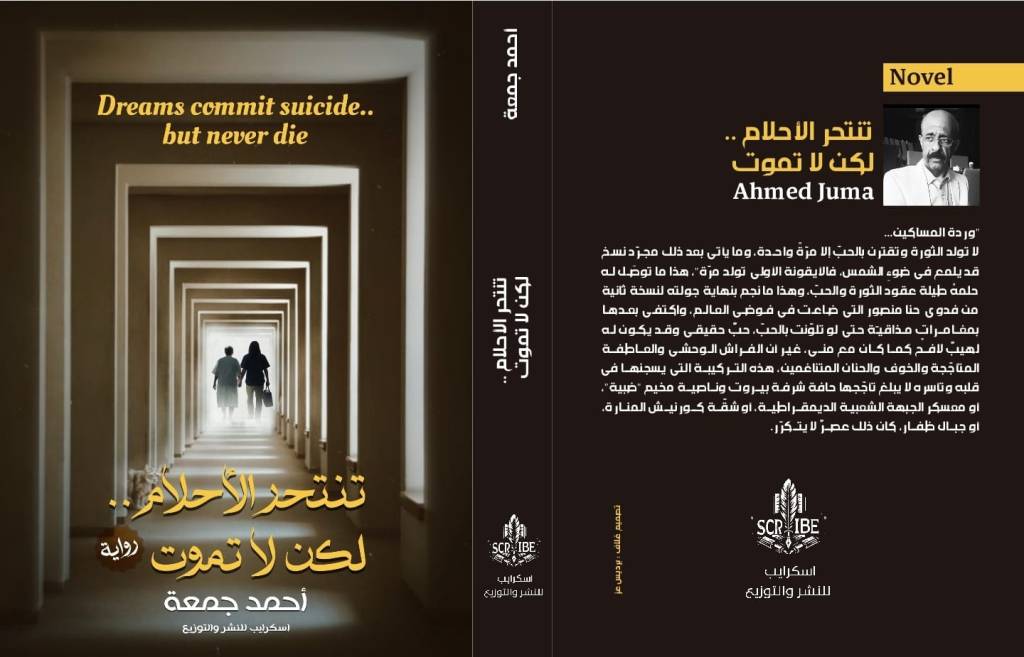
فكرتُ بالهرب منذ وقت طويل، منذ بدأت أوشك أن أفترق عن فدوى حنا منصور وحتى شيرين جابري، الشيء الذي أجلّ هذا الفرار رغم توقي إليه، الالتزام بالأسرة التي كلما تطلّعت فيها لوجوه الفتيات والشباب شعرت بأني أخون أثمن أمانة بعنقي أهدتها الحياة وقدمتها لي، وإلا منذ أن أصابني أول سهم من الوطن وشعرتُ لأول مرّة بعد الرغبة بالبقاء أو الرحيل، كنت أشعر بأنهُ منفى والغربة فيه أشدّ المنافي ولكن يظلّ هواءه حتى لو عفَّن وخريفُ حتى لو كان غباريًا وحتى أيضًا صيفه جحيم الآخرة في الدنيا، رغم ذلك يبقى المكان الذي ولدت فيه الذكريات بشجنها ولهوها، بزخمها الذي لا ينضب والتي مهما قصيت ستلاحقك حتى لو كنت تعيش في مجرّة الفضائيين. كانت ليلة شتائيّة مقفرة، لفظت فيها السماء رصاصها المطري الهائل والذي لم تشهد مثله البلاد منذ عقود، خرجت ترافقني لعنة الشوارع الممطرة التي طالما عشقتها وفضلت عليها الهروب من المنزل بمنتصف المساء الذي في ليلة داكنة من وراء أسرتي لأرتقي بذوقي الكتابي مستغلاً هذه التراجيديا الطقسيّة، كنت أنوى التمتع بساعة زهو لا تسعفني فيها الحياة برؤية هذه المسرحية السماوية إلا في سفراتي المعدودة بشتاءات نادرة أو في الأفلام الأجنبية التي تسحرني أجواؤها المقفرة عندما تحاصرني الأمطار وأخوض بالسيارة كسمكة في الماء وقلبي مضطرب خشية تعطُّل المحرك بقلب بحيرة سحيقة، منظر يندر أن تصادفه في جزيرة طيلة فصولها شمس حراقة وغيوم مخادعة وأجواء كرنفالية بلا مغزى، يندر أن ترى لوحة شتائيّة كما في باقي الكرة الأرضية، هذه الليلة أفقدتني صوابي فقرّرتُ المجازفة بعد أن طويت الوقت كلهُ أناور بين الشارع المحاذي ومحيط المنزل مع بعض أفراد الأسرة الذين شغفوا بالطقس ولكنهم جمدوا رعبًا. ومع انتصاف الليل وتغييب الطقس للأذهان، أوهمت الجميع بنهاية نهاري وليلي، واستدرجت طاقة التحايل التي يبدو أنّها لم تنضب بعد من المراوغة فيما يتعلق بالمجازفات فهربت من المنزل منتشيًا.
كانت الطريق وعرًا لم أتخيّل قرية بمدينة المحرق منذ ستينيات القرن المنصرم حتى الآن بالألفيّة الثالثة لم تخلع ثوبها ولم تتزين أو تتعطر أو تمشط شعرها، لا أتصور هذه المنطقة بالذات المحاذية لما كان يطلق عليه داعوس أم حمار صعودًا حتى التلة اليتيمة التي تقع على أطرافها بعض البيوت القديمة حتى أنهُ لم تخفِ عنها صورتها الأصليّة رغم ما مسها من ترميم وترقيع إلا أنها كما يبدو ما فتأت تحتضن نفس الوجوه المعدمة حتى لو كانت من الأبناء والأحفاد، دليل ذلك هذه السحنة المستعصيّة على التغيير والتي تصبغ المنطقة برمتِها قد أعاقتني عن الولوج بالسيارة وسط هدير الأمطار، والمستنقعات التي تؤذن بتحوّلها إلى بحيرات رادعة للعبور ما وضعني بين خيارات صعبة ومتعدِّدة لبلوغ التلة الأخيرة المطلّة على البحر والتي تعلق من خلالها أغنية أم كلثوم أنت عمري بنهاية الستينيات عندما تورَّطت ذات مرّة بجوار عرش جوري الصوري، ملكة مدينة المحرق المتوّجَة على قمة الخرافة الجماليّة، كانت أسطورة عصرها رغم فقرها وانتهاكها، ورغم تدفُّق ضباط جيش الاحتلال البريطاني ورجال المال والتجار والبحارة والمشردين عليها، كانت تمازحهم وتشرد معهم من عالمها المُعتم، كانت عنوانًا للفرح الدائم لمن حولها وعنوانًا آخر لحزن الكرة الأرضية لأمثالها وكل من عذبه الفقر والهوى والذل، لم تكن تعرف الثورة حتى بذروة انتفاضة مارس 1965 كانت تبتسم وتمزح مع بقايا الهاربين من أنفسهم ليسفكوا معاناتهم عند قدميها، كانت حينها بعيدة عن أجواء الثورة، هذه جوري الصوري التي ملأت سيرتها المدينة الرمادية منذ ستين سنة غبارية، ثم ابتلعتها المدينة مع آلاف المعذبين، وكان آخر ما خلفّتهُ من ذكرى ما ورَد برواية “خريف الكرز” وبصمات كلمات دلال القوادة لها وهي توصي أغنى رجل بالوطن حينذاك وما زالت سلالته قائمة…
“اسمع تقي، جوري ما زال شراعها مغسولاً ومتألمة مما جرى لها على يدك آخر مرّة، ولن تشبعك الليلة وهي مجروحة، ادخل ولاطفها وداعبها، ولكن لا تُبحر فيها، تعال بعد يومين أوضبها لك وستدخلك الجنة… تقي”
خرجت ليلتها وانا بجرحي القديم بحثًا عن رائحة تلك الحقبة الرمادية وعن جوري وسلالتها، لماذا اخترت هذه الليلة المجنونة بالذات لأغامر بسيارة لا تتسع لها طرقات ومستنقعات القرية ولا مجال للمشي فيها في ظلّ هدير مطر همجي وموجة برد لم تمرّ بالبلاد منذ الستينيات عندما نفقت الأسماك وملأت السواحل مع تساقط حبات البَرد بأحجام غير مسبوقة، لم أعشها بوعي يحفظ تفاصيلها إلا مع بعض ذكريات ذهنية ضبابيّة وروايات داعمة، تصوّرت ما كان حال أولئك الآباء والأجداد ورواد الحانات والدور السريّة ومعاناتهم في الهوى واللهو والبرد والفقر. مرّ ذلك كشريطٍ سينمائي خرافي بينما ظلّلت أفتش عن مخرج للمأزق الذي علقتُ فيه بسيارتي وقد حشرت في طريق ضيق ملأتهُ المياه ولم يعد بالإمكان العودة للوراء أو التقدم أكثر، لقد انزلق في بركة لا خروج منها إلا بدعم من الدفاع المدني! تُرى ماذا يدور في مهجة هذا الرجل وما الذي أفقدهُ عقله وأتى به في ليلة كهذه وبوقتٍ كهذا في هذا التوقيت الأسطوري؟ هذا ما تخيّلت أنهُ سيدور على لسان أهل البحرين كلها!
“المهم، ماذا أفعل الآن، أصعد المنحدر الذي لا أعرف ما يخبئه أسفلهُ من مياه قد تغرق فيه السيارة قبلي؟”
“كنت أستمع بالسيارة للموسيقى دون تركيز، لقد اختفت رغبة المجازفة لدي وإن ظلّ شغف حاد يقودني للأمام كلما خُيّل لي أنّني أقترب من دار دلال القوادة وحكاياتها وطيف جوري الصوري، رأيت أن الأمر يستحق العناء، فانزلقت بالسيارة دون أن أعبأ بالعواقب، ألست من جازف قبل نصف قرن وساح ببهجة دون خوف حين طفت في بيروت أثناء الحرب الأهلية ومررت بعدن مركز الثورة الماركسيّة وجازفت في جبال ظفار، هل كان هناك ذعر؟ هل احترت أو سدرت كما اللحظة بين أمطار متعجرفة وطرق مراوغة ومتاهات قرية صغيرة بالوطن كُتب أن تضيع من الخريطة كما يبدو جليًا من بقائها كما كانت عليه منذ خمسين عامًا؟ خلال هذه الفترة القصيرة تسأم الأصدقاء الذين نزحوا من عالمك وتسأم تحجرهم، تخفت حدّة ذكرياتك فجأة مع الزمن ولكن بليلةٍ تقفز بغتة من فراشك الدافئ، تلاحقك ذكرى جرح قديم استيقظ من نومٍ طويل كما هو حالي في هذه اللحظة. غادرت الدفء وانخرطت في شوارع وطرقات قرية حالة أبي ماهر جنوبي مدينة المحرق”
في هذه الليلة الفريدة، التي هدَرَتْ فيها السماء سيلًا جارفًا من الأمطار، رعدت وصعقت غيومها الداكِنة بعضها ببعض، وأسْرفتْ في إراقتُها، حتى لم يظلّ موضع لم ينفذ إليه المطر، كانت ليلة عنيدة لا هوادَة فيها، اكْتظَّت فيها السماء بغيومٍ سوداء غير مسبوقة كما القيامة، خيمت موجةٌ مبرحة من بردٍ جارحٍ كالسكين، تغلغلت لعظامهِ رغم تشغيله جهاز التدفئة بالسيارة.
مرّت رؤيا غرائبيّة بذهنه لجثةٍ مُلطَخةٍ بالوَحل، لهث كالبهيمة عندما حدَّقَ فجأة في طريقٍ قديمٍ قادهُ للخروج برجفةٍ، ثم مضى بهدوءٍ وتركيز عبر زاويةٍ من الحي البحري القديم الذي جمعه ذات وقتٍ مع بعض ثوار جيله، ولدى منعطف الزقاق المؤدي لِتلَّةِ الطين، من خلفِ دكانيّ خلقون، وعبد الرحيم، انتزعهُ صوتٌ من بعيد دعاه للصعود نحو التلّة حيث كانت تنزوي هناك كومَة من منازل التَنَك الفقيرة تحيا فيها ثلةٌ من الأسَر المُفكَّكة، تنوء في بؤرَةٍ مُعدَمَة، وقد تخلى بعض أفرادها عن أبنائَهم بسبَّب الفقْر أو الفضيحة.
انْبرت جوري تفْتن كل من على المجرّة وهي تدب بقدميها الصغيرتين وصوت وقعها على الأرض ينساب في الفضاء، كانت صبيّة يافعة تضارع السادِسة عشرَ ربيعًا، بشرتُها اللبنيّة اللون تشي عن طراوة جسدها، قوامها المتناسق المدى، ينحى إلى النحافة، مكْتنِزة الردفين والفخذين، لها ساقان سامقتان، ونهدان صغيران نافران وعينان واسعتان رماديتان تذْكو بنكهةِ البحر. تُذكِّر الخلق البشري بمشيتها الأخاذة وهي ترتج بالأرداف الساحرة على إيقاع ضوء الأمسيات المحرقيّة الرمادية، كريشةٍ محلقة في فضاءٍ تداعبها تياراتٌ ساخنة وباردة بحسب المواسم، آتيّة من بيئةِ ساحليّة للبحر الأزرق النضر، كما لون الألماس المنسكب جنوب مدينة المحرق…تُحلِى معِصَمَها طوال الوقت بخيطٍ أسود اللون من فتلِ الحِبال، لم تلزم نفسها بالمطلق الردّ على كلِّ من سَألها عنهُ، كانت متفائلةٌ به حتى يثبت العكس. دفعتهُ هذه الفجوة التي انفجرت أمامهُ فجأة بينما همّ بصعود تلّة تموج قاعدتها في دربٍ مجهول أخفتهُ مياه غزيرة وإن ظنّ عن معرفة قديمة بأنها تلّة دار جوري الصوري وقد تمّ ترميمها وطليها ولكنها بنفس الزاوية وذات السبيل الذي يقود للمنزل الكبير لدلال القوادة، وكان هذا الطريق هو سبيل جوري اليومي تسلكه ذهابًا وإيابًا وقد كانت تسميه طريق جرح الهوى وكثيرًا ما تتعرض أثناء مرورها فيه سواء بالليل أو النهار لتحرُّش مختلف ذكور الحي وحتى الأحياء المجاورة، لقد كان طريق الدموع واللهو والذل.
عندما همّ بالمضي والصعود خفقَت السيارة في هُوّةٍ توقّف محركها وكان هذا ما توقعهُ وخشى منهُ. كانت الساعة الثالثة إلا ربعًا وبدأت مياه عفنة تتسرّب من أسفل السيارة، خاف أن يغرق وهو بداخلها.
“يا للهول، بمن أتصل الآن وما هي ذريعتي في وجودي بهذا المكان والتوقيت؟” تلفّت حوله فلم يجد حتى المظلّة الواقيّة، تذكَّر أنّها بصندوق السيارة ونصف السيارة الخلفي يقبع في بركةِ المياه. مرَّت دقيقة ظنّها سنة حسم فيها أمرهُ وخرج مفضلاً أن يتبلّل نصف سرواله من أن يستسلم بيأسٍ في سيارة تغرق، خرج بسرعةٍ باهرة أذهلتهُ هو نفسه حتى بلغ رأس التلّة واحتمى تحت سقف باب الدار الخارجي وبدأ منذ حينها يرتعد ويتهَّدج صوته الداخلي وإنهُ على وشكّ أن يغمى عليه، وقد ذعر من مجرّد طرق الباب بهذه الساعة التي يقارب فيها الوقت من أذان الفجر لو خمن كما بليلِ الشتاء. وأيّ شتاء همجي هذا؟ ظلّ يُجرب الاتصال بابنهِ دون جدوى وتخيَّل أنهُ يغط بحلمٍ بنفسجي، أما التفكير في ملاكه الحارس ابنته، فهذه كارثة يجلبها لنفسهِ والأفضل لهُ أن ينتحر بطقسِ الليلة المعتوهة عن مجرّد أن يخرجها بهذا التوقيت.
“أيّ جيل يسكن هذه الدار بعد نصف قرن وأكثر؟” كلما مرّت الدقائق كلّما شعر أنهُ يقترب من التجمُّد، حتى أخذ لسانهُ يرجف، وشفتاه تستعصيان على الالتحام، وراحت رئتاه تضيق وشعر باحتباس نفَسه، قسى على ذاتهِ وأخضعها لغريزة البقاء، فالحياة تختبرهُ هنا أكثر مما فعلت معهُ في عواصم الأمس، وهذه الغريزة وحدها استنفرت شغف البقاء، فدفعتهُ لطرق الباب بشدّةٍ من دون أن يشعر بشدّة طرقاته لتجمُّد يداه وخلْوها من الإحساس. ظلّ يعاني من بوادر احتضار من غير أن يجد مخرجًا للعودة بالسيارة الغارقة والانتظار في الزمهرير مع امتداد فضاء المجهول على المدى الذي لم يتصوره عندما خرج للاحتفاء بالطقس وقد سيطرت عليه فكرة مرور غرائبيّة بالعودة لذكريات ماضٍ موشوم بالخيال يدعم فكرة الكتابة لديه. عاود الطرق هذه المرة مستأجرًا كلتا يديه، ثم استند على الجدار واستسلم لأفكار ملونة من بينها الاتصال بالدفاع المدني. فجأة وبينما يعد الأفكار وهو يرتعش فتح الباب أخيرًا عن وجه علته الدهشة المرادفة لذعر طبع قسمات فتاة عشرينية بدت مسحورة من وجود صنم متحرك يرتعد وينظر لها بلا ردة فعل، وكأنما فقد الإحساس بشيء حوله.
جمَدت صبيّة مراهقة تناظر العشرين سنة، بدت ناعسة رغم الدهشة التي طبعت بشرتها السمراء فاتحة اللون وبرزت نحافتها تشي بطراوةِ جسدها، كانت مكْتنِزة الردفين، وذات نهدين صغيرين نائمين برزا من قميص النوم وفوقهُ لفّت جسدها الأعلى ببطانيّة زهرية.
“من أنت وماذا تريد؟ ابتعد وإلا-توقّفت عن اكمال جملتها بعدما رأتُه يرتجف وقد تبلّلت ثيابه وبدأ بسنِّ من لا يقدر على مجازفة أو اعتداء- من أنتَ؟”
بلع ريقه، وتنفس بصعوبة، وزاد صمتهُ وكأنهُ أبكم، فما كان منها إلا أن أغلقت الباب بوجههِ، وخلّفتهُ غير مصدق أنهُ عجز عن النُطق بكلمةٍ، ظنّ إنهُ يحتضِر فجلس على العتبة وراح يحاول يائسًا الاتصال بالهاتف من دون أن يضبط رقم الطوارئ أو الدفاع المدني. كان البرد هو الذي شلَّهُ وقارن حالتهُ بحقبةٍ من شبابه ومغامراته في عدن وبيروت وظفار وحالته الراهنة الآن، فأدرك فارق العمر والتحمُّل الذي اضطره أن يستعيد ذكريات ظفار والحرب الأهليّة اللبنانية ليعضِد طاقتهُ الخياليّة لتُعينهُ على البقاء حتى يسعفهُ الدفاع المدني الذي بدأ محاولات يائسة دون أن يتمكّن من قبض الهاتف بكفهِ المُتجِمد حتى أدركهُ الخدر، وبينما مضى يقاتل في محاولات الانقاذ حتى فُتح الباب مرّة أخرى وأطلّت الصبيّة بعد أن وضعت على رأسها غطاءً ولفّت جسدها بقطعةِ شال من الصوف، حدّقت به فيما كان يرمقُها غير متيقِّن بالمطلق من أنّها عادت تنظر لهُ حتى أنّها لمحت عينيه مترقرقتين ليس بالدمع كما خُيِّل لها، ولكنه بريق الذكريات الذي أفقدهُ الإحساس بالمكان والزمان.
“أنت طيب من ملامحك ولا علاقة لك بأذى، ما الذي ألقى بك هنا؟ وعن ماذا تبحث؟ – توقّفت برهة ثم انحنت له لترى وجهه المُعتّم إلا من حيّزِ ضوء شاحب تسلّل من فتحة الباب الذي تركت نصفه يخرج منهُ الضوء. ثم أردفت – هل تضمن ألا تعتدي عليّ لو أدخلتك وسخنّتك؟”
“جئت أسال عن امرأة كانت تدعى جوري الصوري كانت تقيم هنا قبل خمسين سنة”
أمسكته من كتفه وأسندته لتساعده على الولوج وبالوقت نفسه أبدت تشككًا كفرع من وسيلة حماية نفسها من لو بدا مخادعًا مراوغًا مع أنهُ لم يستطع حتى صلب نفسه ولكنه انتصب كما لو قوة طارئة خرقته لشدّة عدم التصديق أنهُ لم يُنقذ فقط وإنما قفز للداخل، كان يغمغم فيما كانت تجره حتى أسقطته على كنبة مستطيلة لم يلمح حتى اهترائها، وضعته بالصالة وركضت، وخلفّتهُ يتأمّل الصالة المُثلثة غريبة الشكل والتي اكتست ببضع مقاعد مختلفة اللون والحجم والشكل، كانت هناك نار مطفأة وبجانبها مطفأة سجائر امتلأت نصفها وخلفت سخامًا كما امتلأ برميل تم قص نصفه وجُعل منهُ مدفئة زخرت بقطع الفحم بجهة وفي جهة أخرى بقية جمر أوشك على لفظ أنفاسه. كانت السجادة ملونة من قطعتين، إحداهما خضراء اللون سادة والأخرى حمراء مشجّرة أطرافها وقلبها منقوش بزخارف صغيرة، علقت بها بعض قطع أوراق المحارم المستعملة والممزقة. كانت هيئة الدار تبدو مهملة منذ وقت ولم يظهر من سكونها الصامت أن هنالك من يشارك الصبيّة العيش فيها. رفع رأسه أول ما لمحها وهي تندفق نحوه لتضع قدح الشاي بين يديه ثم تُلقي على ركبتيه قطعة بطانية، كان غطاء رأسها يوشك على السقوط وبرزت خصل شعرها البني بالغ النعومة وقد جلست قبالتهُ واسندت ظهرها للوراء وقالت بنبرةٍ لم تخلُ من تنبيه:
“تسكن معي هنا خالتي، وهي نائمة، ولكنها شديدة اليقظة لهذا أحاسب ألا أوقظها ولو كانت صاحية لما سمحت بإدخالك، ولكن يبدو أنكَ متورِّط بهذا الطقس اللعين وإن لم يكن بشيءٍ آخر”
“تعطَّلت سيارتي أسفل التلّة وغرقت للنصف بالمياه، كما أنّني لم أرغب بمضايقة أحد من معارفي بهذا التوقيت والحالة، ومن بإمكانه المجازفة والمجيئ بهذا الطقس كما ترين أمامك؟”
بدأت تهدن وتتيقن من نيته الداخلية وبراءته، ولمحت جزءً من غابة الحزن تغصّ بها سحنته، كما لمح فيها سحنة جمالية تكاد تكون ساحرة مختبئة وراء الإهمال العفوي، كما وارتأى من وراء قسماتها لونًا خمريًا نادرًا ذو طلاء محرقي يعيد الانطباع لصبايا حقبة الخمسينيات والستينيات. كان يشعر بألمٍ حاد في ساقيه منذ أن ولج الدار ولكن كتمّ الأمر بكلِّ ما بإمكانهِ التحمُّل، فبدأ يدلك ركبتيه بحركةٍ عفوية من دون أن ينتبه أنّها باتَت لا تتصرّف وهي تخْتلس انتباهها نحوهُ دون أن يرمقها أو تلفت انتباههُ فيما كانت تمتصّ بداخلها آلامه، شعرت لومضة بإحساسٍ غرائبي يدنو منها ويغرس فيها عاطفة رغم تناميها مع صورته وسكينته مع هدوء لم تعرفه من قبل فيمن كانت تلتقيهم من رجال متبايني الأمزجة والأهواء، حتى بظروف أهوَن من هذه بكثير.
“هل تعاني من ألمٍ حاد بساقيك أو ركبتيك؟ لا تتحرَّج مني، يبدو إن مياه الأمطار جمدتهما-صمتت ومضة وأردفت- ما رأيك تخلع أن سروالك كي أجفّفه لك وتلفهما ببطانيّة؟ لو ظلّلت بهذا الحال ستجلب الشلّل لركبتيك لا سمح الله”
ومن غير أن تنتظر منه حركة سحبت البطانيّة الرطبة التي غطت بها ساقيه منذ ولج وسألتهُ وهي مبتسمة عن ثغر باهر بدا له يماثل قلب محارة كما تراءى بخياله منذ طفولتهِ من ذكريات البحر مع الخال.
“هل تستطيع خلع سروالك بنفسك؟” أكّد لها ذلك بهَز رأسه، فنهضَت وانصرفت وعندما عادت ورأتهُ يقاتل محاولاً خلع السروال بعدما علق بساقيه المرتجفتين، انحَنت ودون إذن منهُ سحبت السروال بغفلةٍ، ولفَّت ساقيه ببطانيّةٍ دافئة قديمة، مهترئة لكنها نفيسة، انتزعت منهُ سرواله، وتعرّت ساقاه فصدهما بيديه الواهنتين لتمويهها لدى انفعاله من الخجلٍ أمام الصبية، وقد أضحى على هذه الحال التي شعر بها اللحظة ولكن لم يبلغ به الأمر لتصوّرها الليلة الأخيرة في رزنامة العمر، فهو يعرف معرفة المنجم وربما الأبعد منه أن وقته لم يحنّ فما زال هناك مهام غاية بالأهمية والسرية والشخصية يتحتم عليه ترتيبها ولكن ما كسرهُ الليلة إنها المرة الأولى بحياته التي يواجه فيها امرأة، بل وصبيّة وهو بهذا الذل الذي قد يخيَّل لها فيه أنهُ مجرّد عابث بسن الرذيلة من أولئك الذين يفرضون عليها نفَسَهم الكريه، لم يظنّ ولا بخياله أن تضعه الحياة أمام امرأة، ويكون مكسورًا أمامها وهذا ما دفعه للتحامُل على تعبه وستَر ساقيه بالبطانيّة بعد أن سلّها من يدها وبدأ يتظاهر باستعادة قواه، وقال بنبرةٍ ملؤها الحافز باسترداد رجولتهِ التي فقدها بالتزامُن مع شفقتها عليه التي دفعتها في البدء لتغلق الباب بوجههِ ثم فتحتهُ بعد مضي الوقت، لتفاجئ به لتحمله للداخل.
“من أنت؟ وما الذي حمّلك على الخروج الليلة؟ لا أظنّ أنك تعرفني، لا تخدعني، ألتمس منك ألا تؤذيني، أعرف بحدسي أنكَ من الطيبين حتى لو كان في ماضيك سوء، من منا لا يحمل خطيئة؟ حتى الأنبياء أخطأوا هذه ما تعلمته من خالتي التي لا أعرف إن كانت على حق وقد ورثتها-ترددت ثم استأنفت- رجاء فقط لا تؤذيني، ابق هنا حتى تسترد قواك وأنا لن أتحرك حتى تغادر بالسلامة”
“ذكرتِ لي منذ قلقل أنك تعيشين هنا مع خالتك، وأذكُّر أنّني سألتكِ عن جوري الصوري إن كانت تعيش هنا ولكنك تجاهلتِ سؤالي”.
حدقت به كما لو أن جيوشًا تطاردها، وتصادف انفعالها مع صوتٍ متناه قادمٍ من وراء الأفق يعلن أذان الفجر الذي انقطع قبل أن يُكْمل ولعل شدّة العاصفة الخارجية أخرسته، هذا ما دار في ذهنه من دون أن يفقد إحساسه بردة فعلها التي ما برحت تتفاعل وتظهر آثارها على بشرتها التي ازرقت، فسارع بتخفيف نبرته واسترداد ضعفه الذي أبداه منذ قليل وأعاد صياغة عبارة شكل كلماتها.
“اعذريني إن أخطأت بذكر أو تكرار الاسم، لم أعنِ إساءة بقدر ما هي رغبة فطرية بداخلي منذ سنين لهذا المكان وأُناسه الفقراء الطيبين الذين عانوا مرارة الزمن الذي عاشوه، سامحيني يا كلك طيبة فما أن يتوقف هذا السيل في الخارج حتى أغادر ولا أنسى معروفك معي أبد العمر”
صمَتَ وهلة حتى لاح الهدوء عليها، وعادت ابتسامتها تضئ وجهها وبدت مسترخيّة، فأردف:
“سيارتي أسفل التلّة معطلّة، بمجرّد توقُّف المطر سأخرج مع كل مودة وتقدير”.
“هل لك عائلة وبيت وأولاد أو أحفاد؟”
بعد سؤالها هذا المُتخم بالمحتوى والفحوى منهُ في ضوء حشره هو لاسم جوري الصوري، لم يتوقف الكلام بينهما حتى أشرق ضوءٌ أرجوانيٌ حاد من بين ثقوب الستارة الشفافة الممزقة بعض أطرافها وجوانبها. لقد انفتحت شهية شهريار وشهرزاد ولم يتوقفا عن الكلام المباح، فخاضا بشرق وشمال المدينة، وفكّكا الأجيال العتيقة ونبشا ماضٍ عتيق لم يُصدق أن هذه الثروة الأرثيّة للأولين محفوظة في خزائن ذاكرة فتية كهذه الصبيّة التي توشك اللحظة أن تقترف خطيئة الاعتراف له، كانت على حافة بلوغ رأس الفوهة من الحديث، حتى عندما ذكَّرها بسرواله إن كان قد جفّ تجاهلتهُ، واسترسلت في حومة اندفاعة حماسية قطعت خلالها الكلام المباح عدة مرات خلال الليلة الطويلة ونهضت تطلّ على خالتها التي اكتشفتُ أنها شبه مقعدة، وفاقدة لإحدى عينيها والأخرى لا ترى منها جيدًا، ومرات كانت تعد الشاي الذي أضافت معه وجبة خفيفة من البسكويت السكري وبعض الفاكهة، كما غيرا مكانهما مرتين من دون أن يشعرا إلا بين فينة وأخرى بمدّة الوقت المنقضي حتى أنهُ أضطر للاتصال بزوجته وشرح لها سبب غيابه بتمويهٍ وإيجاز، وعاد للحديث وكانت الساعة قد جاوزت حينها العاشرة وسبع دقائق من دون أثرٍ للشمس سوى أن المطر تحوّل لرذاذ.
“حتى الآن لم تبلغيني باسمك وكأنما هو وحده السرّ الذي سيظلّ مدفونًا في هذه التلة، لست متطفلاً لك الحق في اخفائه، ولكنك عرفتي عني كل شيء ولم ابلغ حتى شرفة إن كنت سمعت عن جوري هذه التي أتت بيّ في ليلة هاجت فيها مهجتي من دون أن أعي ان كل هذا سيقع لي”
عندما لمحتهُ خلسة وقد عادت لهُ الرجفة قليلاً أسفل ساقيه أضافت له بطانيّة أخرى أصغر حجمًا وقد وازرقت بشرتها وهي تشعر بانفعالٍ حاد لما حدث لهُ، وسرعان ما أبدى في داخله ندمًا على اجترار اسم جوري ولكن عزا ذلك لتفاعلهما بالحديث وميلها للبوح، ولكنه لاحظ توجسها من ذكر جوري وقد زاد الطين بله عندما عاود ذكر الموضوع بذريعة الاعذار، فكان من رد فعلها مباغتًا لهُ عند قولها مع ابتسامة مقتضبة لم تخفِ ارتياحها الجواني وهي تدفع بها، وكأنها كانت بحاجةٍ في أعماقها لهذه الضغوط من قبله لتنفجر فجأة:
“أنا جوري! نعم أنا جوري لماذا الصدمة؟ هل لأنّني لم أكبر، سريّ أني أضع ناموسيّة كونيّة تحميني من الشيخوخة”!!
انفعل حينها وتغيّرت ألوانه، وأضحت الصبيّة بغتةً كزمرة أطياف بوجوهٍ مكرّرة في مرآة تعكسها، وحين رأتهُ وهو يكاد يتحوّل لطيف هلامي في الفضاء الصغير من حولها، قفزت من مكانها، وأسقطت نفسها تحت مقعده وجلست تُحدق به وسط ذهوله الذي قطعته بقولها:
“لقد اسموني جوري تيمنًا بها، ولا أعرف أو أفهم لغز تسميتي هذه بمن كانت أشهر عاهرة في مدينة المحرق و…”
“قاطعتُها مذهولاً وأنا لا أصدق أنها وقعت في خطيئة الاعتراف، ولشدّة ذهولي من هذه الخطيئة الشنيعة بذلت جهدي لتحسين اعترافها الذي بدا مهينًا على ملامحها، فقلت منمِّقًا نبرتي لتلائم صدقي وأنا محق بذلك”
“لم تكن جوري الصوري عاهرة أبدًا، أولئك الذين افتروا عليها، ولوثوا سمعتها، وشنّعوا بها وخاصة النساء الغيورات من جمالها، كل هؤلاء كانوا هم العُهر والفاسقون وقد تلطخوا بالنذالة. إن ما مرَت به جوري وقصتها توحي بأنها كانت ملاكًا لم يجد مكانًا في الأرض بين البشر ففضح عهرهم من خلالها”.
أشارت له بيدها لمنحها فرصة التعليق أو السؤال فقالت منفعلة:
“هل تعني أنها لم تخرج مع الرجال، وقصتها مع قاتل زوجها بعدما أدركت أن جريمته يمكن تمريرها؟”
بدا منفعلاً بدوره، وبدأ ينسلُّ من حالة التجمُّد وقد عاد بنبرة من خرج من وضع البلبلة التي رافقته منذ حلّ بالليلة المنصرمة.
“أكملي ما بدأتيه، وسأثبت لك أنها كانت ملاكًا، رغم كل ما أشيع عنها من ظُلم وتعسُّف، لقد جئت الليلة بالحالة التي شهدتي لي فيها ما حصل للتأكُّد من أنها عاشت على هذه التلّة منذ سنوات الرماد، يبدو أنّني عندما وجدت سبيلاً لإضاءة الصورة لك استطعتُ إضاءة طريقي الذي بدأته”
“هل أنت كاتب؟” سألتهُ واكتفى بهز رأسه، وقال يدعوها لتُكمل ما جرى معها ولماذا سُميّت باسمها؟
“قيل إنهُ لا يعرف لها أصل، وقد تخلى عنها الجميع ونُبذت، هذا كله روته لي خالتي شقيقة والدتها بعد أن تبرأ منها الجميع، لقد كانت منبوذة منذ كانت في التاسعة من عمرها بحجّة أنها استدرجت صاحب الدار وهو رب أسرة كانت تخدم لديهم وأغوتهُ، ومنذ ذلك الحين نبذها الجميع ولكن خالتي قبل سنتين فقط وهي تتنبأ كل يوم بموتها وقد أرادت تبرئة ذمتها من النار، فاعترفت بأمور يندى لها الجبين ومنها أنها لم تغوِ الرجل بذلك الوقت، وإنما هو من اغتصبها ولفقت أسرتهُ لها هذ الإشاعة كي تبعد عنهُ الفضيحة لفَقَت، وأشاعت هذه التهمة لها…”
قاطعها وهو بذروة الانفعال:
“هل أسموك باسمها ليمحوا هم بدورهم خطيئتهم، ويغسلوا عارهم بما فعلوه معها؟ ما فهمته أنها اختفت بلا مغزى، ولم يعلم أحد عن سرّها، لم يبرز بينهم من أنصفها”.
“أنت بحاجة لليلة أخرى تقضيها هنا لأسرد لك كل ما روته خالتي، ولكن يقال إنها ألقت بنفسها من فوق جسر الشيخ حمد بمساءٍ شتوي حزين ويقال إن أحد البحارة رأى جسدًا لكائن يطير في الهواء، ويغلفهُ الضباب”
“قيل، ويقال، لكن الخلاصة أن جوري ظُلِمت، ومن أسماكِ باسمها أراد التحرُّر من مستنقع اللؤم والنذالة الذي يغوص فيه مع الآخرين، بالإضافة إلى رغبتهم الابتزازية في التكفير عن ذنبهم وأنفسهم تملقًا لجنة موعودة لهم في حالة التوبة ومن ذعر القيامة.
قضى النهار بطولهِ معها رغم تحذيرها من سماع طرق بالباب وقد اعترفت له بأنّها تتعرض لزيارات غامضة ولا تتردّد في تملق بعضهم من أجل حفنة أوراق نقدية بعضها مهترئة، حتى تمضي بها لتكْملة ما تبقى من الزمن، عندئذٍ انزلق يسألها مداعبًا ومستغربًا رغم اغفاله مضمون كلامه بشأن هذه الزيارات التي أنها بدا تُلّمح فيها لشيءٍ غير محرج ولكنه تجاوزه ودفع سؤاله وهو يضحك:
“كم عمرك الآن؟”!!
“لماذا؟ هل ستخطبني؟” قالتها بنبرةٍ مازحة مقرونة بنظرةٍ عميقة كما لو تختبره في عمق شيءٍ ما من تلك البواعث الغامضة، حتى أنهُ استنبط من نبرتِها أنها امرأة ناضجة وليست مجرّد صبية، وقبل أن ينطق اهتز هاتفه، بدا مترددًا ولكنه أخيرًا أجاب:
“أعرف ابنتي الغالية قلقك، ألم تفسر لك والدتك؟ اضطرّرت للخروج متأخرًا لم أرد ازعاج أحد، خرجتُ لمساعدة صديق وهو في مأزق، الأمور الآن بخير وسأرجع اليوم-قاطعته من الطرف الآخر أكثر من مرّة ولكنه عاد يسوغ الذرائع حتى أنهى المحادثة- والتفت نحو من تُدعى جوري!
“يبدو أن ابنتك تحبك وأنت كذلك”..
ابتسم، وعاد يستكمل الحديث بينهما حتى لا يضيع تلميحها وليسبر غورها.
“لم تخبريني كم عمرك، أظنّ تسع عشرة سنة، ورغم ذلك تتحدثين تعيشين الوقت فقط لتكملة ما تبقى منهُ أرغب في لقاء خالتك وأسألها عنك، ولو في ذلك شيءٍ من الحرج فلا أريد أن أسبب لك مأزقًا”
كانت قد تركتهُ طيلة الوقت الذي انقضى مرات عدة لتلقي نظرة على خالتها من دون أن يسمع أيّ حركة أو نبض يشير إلى وجود كائن آخر غيرهما الاثنان بالدار. كان المطر قد توقف تقريبًا. كان يفكر منذ بضع دقائق بارتداء سرواله بدل البطانية التي ظلّ يحملها معه حتى الحمام والاتصال لسحب سيارته أو معالجتها إن كانت صالحة للسير، ولكنهُ لا يرغب بترك المكان خشية ألا يعود إليه وتنتهي مغامرة العمر الأخيرة!”
“عمري، يا سيد الرجال قد يصدمك، وأُقسم أنهُ الحقيقي، ثلاث وثلاثون سنة، إن لم تُصدق، ولو كان معي جواز سفر لنهضت وجلبتهُ”
كان الوقت يمضي، نهض وارتدى سرواله وسار في الصالة ينظر للخارج من شرفة الصالة، كان الطقس غائمًا رغم بعض الخيوط الرفيعة الأرجوانيّة المتسلّلة من بين شقوق كتل الغيوم الداكنة، لم يعد يشعر بوهن أو ضيق صدر أو كآبة، بدا أن ما حصل معه منذ 24 ساعة انقضت، كان خياليًا، وهو مشروع لروايةٍ مكتملة هطلت عليه مع نكبة الطقس التي لم يعد ناقمًا على كل ما جرى له حتى الآن، بل بالعكس لقد كان هدية أوحى بها خياله الذي رافقه منذ طفولته، هو وراء كل هذه الإنجازات الأدبية الخرافيّة. كان قد فرّ بالليل سرًا فقط للسياحة الطقسية بالسيارة في مشهدٍ رومانسيٍ يذكِّره ويعيد معهُ شريط مجازفاته بسنِّ الشباب الثوري والعاطفي، مشهد لا يتكرّر ولا بعد قرن لأنهُ لن يشهده ثانية، وإذ به يتحوّل إلى دراما اجتماعية من دون تخطيط، عندما لعبت بعقلهِ فكرة ذكرى جوري الصورة وملحمتها بعصرٍ غباري، شهد على تكوين رسم فسيفسائي، لوحتهُ الرئيسية أعقاب الحرب الكونيّة الثانية، من فقر، ودعارة وجوع واستلاب للإنسان كل هذا رمزت له جوري الصوري بلعنة جمالها الذي تمّ استغلاله من قبل رجال أعمال وذئاب مال، وبحارة ومتشردين، ومع كل ذلك لم تسلم من الفقر والضرب وتشويه البشرة حتى ذلك المدعو تقي وهو أحد أبناء رجال المال الأشهر في البلاد، عندما وقع في حبها وشغف بها حد الجنون وجرب امتلاكها لنفسهِ، واستسلمت له وأمِّلت بنهايةِ الذل، هجرها وسافر للدراسة وخلَّفها مُدمرة نهائيَا، وعندها بدأ جحيمها “الدانتي” روى معظم تفاصيل هذه المعلومات التي لم يعش عصرها ولكنه اكتسبها بالمعرفة والتاريخ والرواة، وظلّت أيقونة تلاحقه كلما بلغ حقبة من العمر، تتداعى خلالها الذكريات.
“لو تُعرفيني على خالتكِ وتغرينها بالتحدُّث إليّ سأُعيد لجوري كرامتها الإنسانيّة، معادل محو تلك الحِقبة المظلمة من حياتها، ومسخ أولئك المتفسخين. ليتكِ تغرينها …”
قاطعته مقهقه وقد مطت شفتيها وفاجأتهُ بلمسة من يدها على كتفهِ مبتسمة عن ثغر لم يرَ من قبل مثلهُ، يشي عن تناغم وانسجام، ساد الجوّ بينهما حتى تمنى أن تعود السماء ويتعكر مزاجها وتهدر سيلها لتتجدّد ذريعته في البقاء معها وتعميق ما تعمق حتى الآن. نظرت في عينيه وقالت وقد بدأ عليها التردد، لاحظه هو كما انتبهت هي له.
“لو علمت خالتي بأن رجلاً دخل المنزل واعترفتُ له بما باحت به لي لأعدمتني، لكن أود أن أعترف لك بشيءٍ صدر مني منذ لحظة اقتحامك المنزل وكنتُ في شكٍ منك وريبة من الليلة برمتها ومن حينها لم أستطع أن-صمت وقد ازرق وجهها وبدأت تتعرق في هذا الطقس- لم أستطع…”
” على ماذا لم تقدري جوري؟” سألها وقد توسَّعت حدقتاه.
“لا يوجد بالدار سواي، وخالتي توفّت منذ سبع سنين أو أقل لم أعد أحصِ الأيام”